حرية – (11/8/2024)
في عام 1965 أرسى عالم النفس الأميركي إليوت جاك مصطلح “أزمة منتصف العمر”. وأراد عبر هذا الاصطلاح تسليط الضوء على مخاوف الفرد في تلك المرحلة العمرية، وقلقه الوجودي، الذي يمثل دافعاً سلبياً، يحفزه للقيام بسلوكيات غير منضبطة، كالوقوع – على سبيل المثال – في الحب مرة أخرى، وإقامة علاقة جديدة خارج مؤسسة الزواج، تنتهي عادة بانهيار هذا الزواج، والتفكك الأسري.
وعلى رغم بروز هذه الأزمة في عديد من الأعمال الأدبية والدرامية، فإن ثمة صورة نمطية ترسخت عبرها، حصرت الرجل في دور الجاني، وحاصرته بالنقد، وكالت له الاتهامات. غير أن الكاتب المصري عمرو العادلي حاول كسر هذه النمطية وتفكيكها، في روايته “مريم ونيرمين” (دار الشروق). كما يمهد عنوان النص، يكشف السرد عن امرأتين، كانتا وقود أزمة “محيي الدين أنيس”، الكاتب المرهف، الذي وجد نفسه في متاهة من الحب، والأحلام، والهذيان، وظل يتأرجح طوال الأحداث بين الوهم والحقيقة، الحياة والموت.
انتهج الكاتب أسلوب الميتا سرد. وهيأ القارئ لتلقي النص كرواية داخل رواية، فمثلما كان “مريم ونيرمين” عنوان روايته، كان أيضاً عنوان الرواية التي كتبها البطل وفقدها، وتوهم في موضع آخر من السرد مناقشتها في ندوة. وكذا كان عنوان الرواية التي كتبتها “أروى” ابنة أخته، والتي شكلت أحداثها نسيج السرد ومتنه. كما عمد إلى مخاطبة القارئ بصورة مباشرة في غير موضع من النص، وبدا عبر خطابه، إدراك السرد لطبيعته السردية، ووعي الكتابة بذاتها: “الرواية الآن وصلت إلى منتصفها، ستضطر هذه الجملة القراء أن ينظروا في رقم الصفحة الحالية، ثم رقم الصفحة الأخيرة، سيقسمون إجمالي عدد الصفحات على اثنين في أذهانهم، ويقارنون بين الأرقام وما تبقى من صفحات” ص 180.
تعدد الرواة

الرواية الجديدة
ولم يكن الميتا سرد الرافد الوحيد لما بعد الحداثة، بل إن ثمة روافد أخرى لها، دفع بها الكاتب إلى النص، من بينها تعدد الرواة، إذ وزع صوت السرد على بعض شخوصه، إضافة إلى صوت الراوي العليم، الذي استهل به رحلته السردية، متتبعاً ابنة أخته، وقرارها كتابة رواية، يكون خالها “محيي الدين” شخصيتها المحورية. ثم عاد العادلي ومنح سلطة الحكي لشخوص أخرى، مثل مريم، ويوسف، وفضل الله، ونيرمين. ولم يكتفِ بالأشخاص الطبيعية، بل منح صوت السرد لقط، وفأر، وقطعة ثياب “سويتر”، ولأجزاء فصلت عن الجسد “مخ وساق”. وكانت هذه الأصوات، وسيلته في تمرير الفانتازيا إلى عوالم النص. كما منح عبر مساحات الديالوغ المسرحي، فرصة للشخوص الثانوية، مثل أخت البطل “نجوى”، كي تعبر عن ذاتها بحرية. وتمكن عبر تعدد الرواة، من طرح رؤى متعددة ومتباينة، أتاحت له تشكيل بناء بولوفوني، استطاع عبره تحقيق ديمقراطية السرد.
أشاع الكاتب مناخاً من الضبابية والالتباس في مساحة شاسعة من نسيجه الروائي، رغبة في زيادة التشويق، على نحو يضمن إحكام قبضته على القارئ، وينقله من خارج العالم الروائي إلى داخله، ويعزز حالة التداخل والتفاعل، والتماهي مع النص. وكان تعدد المحكيات إحدى أدواته، التي استخدمها لإضفاء تلك الضبابية، بخاصة أن كل محكية أسهمت في انزياح ما سبقتها، فالبطل الذي سافر إلى الإسكندرية لمناقشة روايته، والتقى في رحلته بشخوص شاركوه صنع بعض الأحداث، ما يلبث أن يتكشف له وللقارئ، أنه لم يبرح القطار، وأن الرحلة والشخوص والأحداث لم يكونوا إلا محض وهم.
تضارب المحكيات
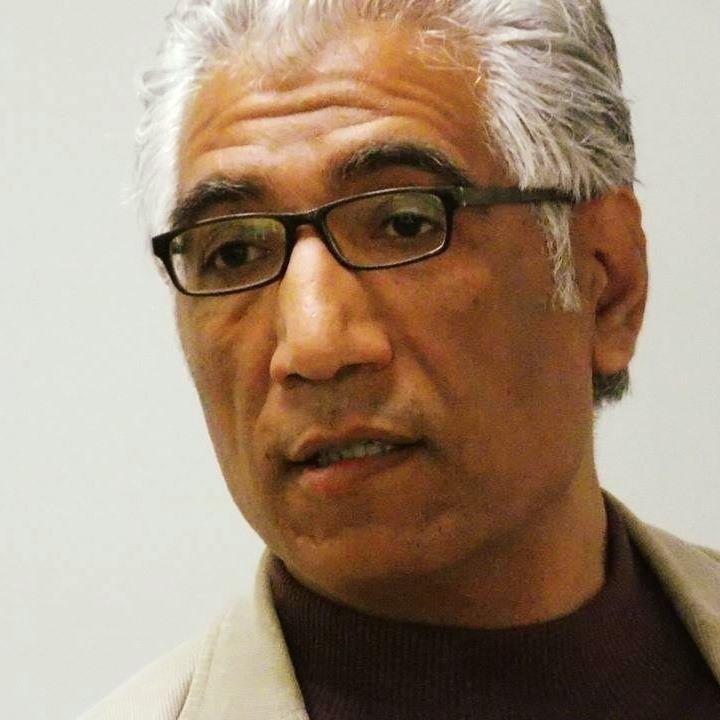
الروائي المصري عمرو العادلي
ونيرمين التي ألتقى بها في إحدى ندواته، ونما الحب بينهما حتى اتخذا قرارهما بالزواج، يتضح في محكية ثانية أنه لم يلتقها أبداً، وإنما التقى أبويها بعد انتحارها، وفي محكية ثالثة يتكشف أنها من صناعة خياله أوهامه، وأن لا وجود لها من الأساس، كذلك المرأة البدينة في إحدى محكياته، هي صاحبة الفندق الذي نزل به، وفي محكية أخرى هي أم حبيبته وزوجته الثانية “نيرمين”، والشج في رأسه، كان نتيجة اعتداء زوجته الأولى “مريم” في محكية، بينما تسببت به حادثة سير في محكية أخرى، وكان نتيجة لاعتداء صديقه “فضل الله” في محكية ثالثة، وفي محكية رابعة تسبب به انفجار في العراق. واتسق هذا التعدد والتضارب في المحكيات، مع تعدد أصوات السرد، واختلاف مرجعيات، وسيكولوجيات، وثقافات الرواة، وعلى رغم تحقيقه لغاية الكاتب في تجسيد واقع مركب، وغامض، وملتبس. فإن كثرة هذه المحكيات، وما كان يكتنفها من تضارب واختلاف، خلال مساحة ممتدة من السرد، ربما يربك القارئ، وقد يشتت ذهنه، ويفلت منه خيوط السرد.
كسر النمطية السائدة
كسر الكاتب الصورة النمطية السائدة في التعاطي مع أزمة منتصف العمر. وتجاوز عادة حصر الرجل في دور الجاني، حين يقع في حب امرأة أخرى، ويهجر زوجته. وصبغ هذا التعاطي بصدقية استمدها من السرد بصوت شخوصه، مستخدماً ضمير المتكلم، فالبطل “محيي الدين” يروي قصة هوة واسعة تفصل بينه وبين زوجته، التي لا تمنحه حباً، ولا دفئاً، بل تحط من شأنه، وتزهق خياله بواقعيتها وقسوتها. وتتسع الهوة بينهما في ظل ما يعيشانه من انفصال جسدي. وعلى رغم هذه الرؤى التي تنحاز إلى الرجل، تمكنت الزوجة “مريم” – عبر المساحة التي تسلمت خلالها زمام السرد – من تفنيد قسوتها واسترجاع – عبر الفلاش باك – صنوف الخذلان، التي تجرعتها في سنوات عمرها الأولى، وبذا تحولت – بالصدقية ذاتها – من جان في محكية الزوج، إلى ضحية في محكيتها. كذلك عمد الكاتب إلى كسر الصورة النمطية للمرأة التي تقع في حب رجل متزوج، فلم يسمها بالجشع، ولا بالتطلعات المادية، أو التشوهات النفسية: “عشت معها بالفعل فترة جميلة، لا يمكن قياسها بالزمن التقليدي المعلق في عقارب الساعات، كانت خلالها أرق مني، وأرقى، الرجل لا يريد من المرأة إلا الجنس، وتريد المرأة الحب بمعناه الرحب، هو يهتم بإثراء خياله، وتهتم هي بإثراء الحياة” ص 76.
ولجأ الكاتب إلى استخدام تقنية التقابل بكثافة، مما مكنه من رصد الهوة الشاسعة بين الزوجين، وإبراز أثرها في انهيار زواجهما، فمنح البطل سمات الخيالية، والرومانسية، والرقة، في حين منح زوجته سمات الواقعية، والجفاء، والقسوة. كما أبرز عبر التقنية ذاتها، حجم التناقض بين شخصيتي مريم ونيرمين. وجعل من هذا التناقض دافعاً، ومسوغاً لقرار البطل، بالنزوح من الزوجة إلى الحبيبة.
طرق الكاتب عديد من القضايا الشائكة، وتعاطى بجرأة مع قضية عدم التوافق الجنسي، وما يترتب عليه من تقويض مؤسسة الزواج. وتعرض لبشاعة الحروب وأثمانها الباهظة، التي تدفعها أجيال متعاقبة. ودلل بمشكلة اللغم في منطقة العلمين (شمال مصر)، الذي تسبب في ضياع ساق وحياة واحد من شخوصه الثانوية “فرج”. وسمح امتداد الفضاء المكاني للسرد، الذي شمل مصر وبغداد، بطرق قضايا أخرى ذات طابع إقليمي، مثل الاحتلال الأميركي للعراق، وما عاشه الشعب العراقي من أهوال، تحت هذا الاحتلال. ودفع العادلي إلى نسيجه، بعديد من الإسقاطات السياسية، حول الديمقراطية الفاسدة، والنفاق السياسي، والقمع الأمني، وتفشي الفقر، وتوحش التفاوت الطبقي. وأحال عبر صوتي القط والفأر، واستدعاء الصراع التقليدي بينهما، إلى الشقاق بين العرب، ومحاولة صدام حسين لاحتلال الكويت، مما سمح للأميركيين والغرب، بتدمير العراق والاستيلاء على موارده: “ذات يوم مشؤم هجم فأر على أخيه يريد افتراسه، فسمح خلافهما بدخول القط، كل ذلك بسبب الكنز المخبأ الذي كان ملكنا جميعاً” ص 290.
الدوائر والتكرار
صلة وثيقة تربط بين الدوائر والتكرار، دفعت إلى تزامن حضورهما في النص، وكلاهما كانا أداتين للكاتب، عمد من خلالهما، إلى إبراز فلسفة التاريخ في إعادة إنتاج الأحداث عبر دوراته المتعاقبة، لذا تدفق السرد فيما يشبه الدوائر المتداخلة. أما التكرار فبدا على مستوى لغة النص، وأيضاً على مستوى المآسي والمصائر، التي تشاركتها الشخوص، فالمرأة التي هجرها زوجها هي مريم، وهي أمها، وهي أيضاً نجوى “أخت البطل”، والفتاة التي أنهك روحها، الاغتراب عن العالم، ودفعها إلى هاوية الانتحار، هي “أروى”، وهي أيضاً “نيرمين”. وأحال الحضور اللفظي الكثيف لكلمة دائرة، إلى نزوع صوفي، بدا في مواضع متفرقة من النسيج: “يحرك عنقه بشكل دائري… لف حولي مرتين… دار دورة كاملة…”.
عمد العادلي إلى استخدام تقنيات الوصف، على نحو يتسق مع اتساع الفضاء المكاني للأحداث، وولوجه مناطق ربما تجهلها شريحة كبيرة من القراء، مثل صحراء العلمين وقراها. وجسد عبر هذه التقنية، وعبر التكنيك السنيمائي واللغة المشهدية، بساطة الحياة وفتنتها قي تلك البيئة، التي تجمع بين الطابع الريفي والبدوي. ونقل مفرداتها المختلفة، مثل عمل قاطنيها بالرعي والزراعة، وطقوسهم وعاداتهم اليومية، كطهيهم الطعام بالطرق البدائية: “خرجنا من الحوش المحدود إلى براح الوادي، لا أعرف من منا يلعب دور دون كيشوت، ومن هو سانشو بنثا؟ ظهرت التلال البعيدة كقطع من ورق مقوى، يلفها وشاح وردي بأهداب زرقاء، كذلك الذي يرسم حدود الأحلام” ص 199.
كذلك أسهم استدعاء اللهجات المحلية، لا سيما اللهجة العراقية، في إبراز الخصوصية الثقافية للمجتمعات والأماكن، التي اختارها الكاتب وعاءً للأحداث، وكذا في تأكيد واقعية وصدقية السرد، وزيادة حالة التفاعل والتماهي مع النص.








