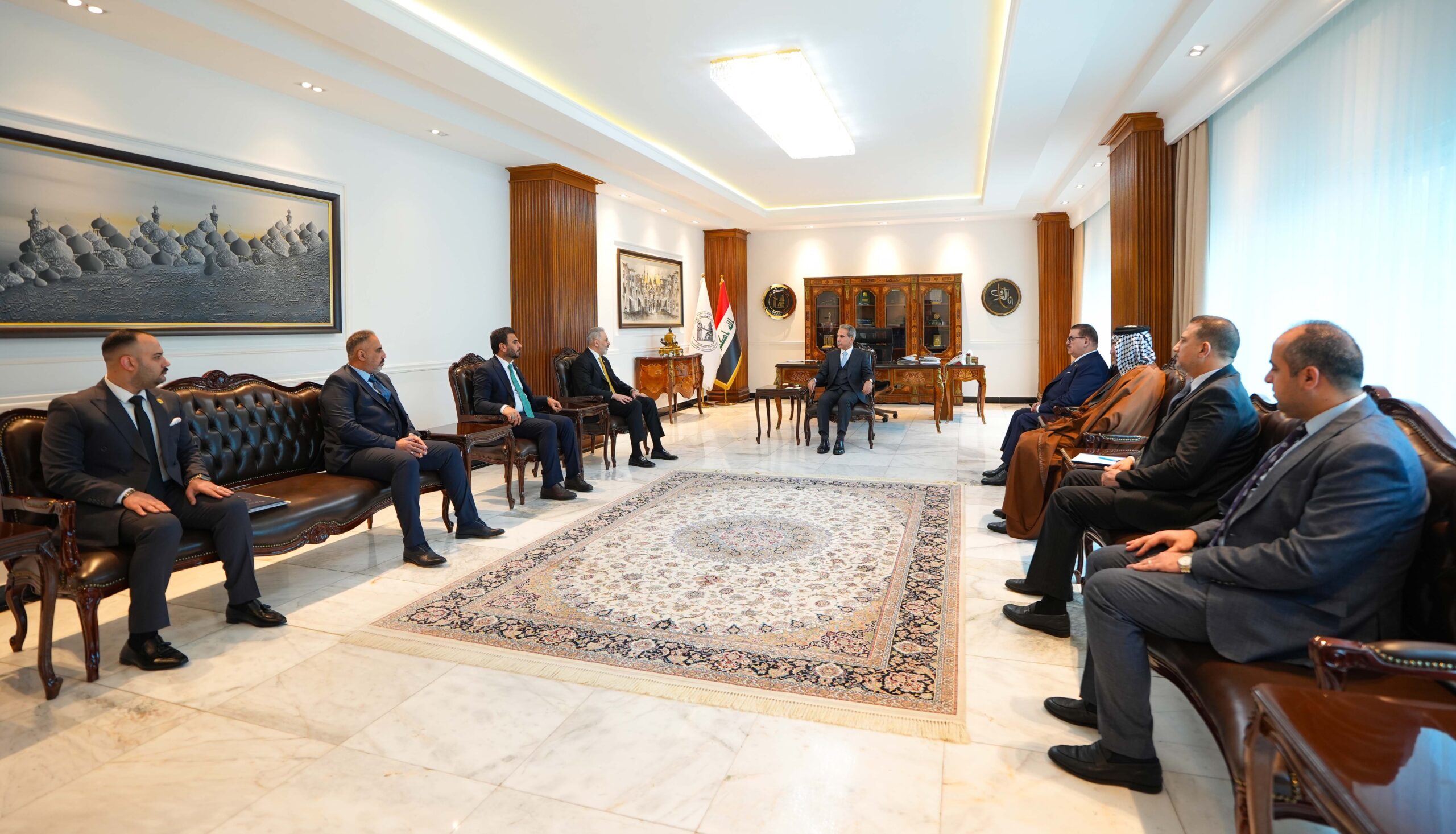حرية ـ (29/12/2024)
.قديماً، قبل ما يقارب الألفين والخمسمئة عام، خرجت البشرية من طور التفكير الأسطوري والخرافي، إلى طور التفكير العقلاني المنهجي، مع نشأة الفلسفة، صديقة الحكمة، وراحت تنسج التصورات حول علاقة العالم المادي بالعالم الروحاني والفكري، على ضوء منهجيات عقلية متفاوتة، من أرسطو وأفلاطون وسقراط، وأفلوطين، وغيرهم. ظلت الفلسفة بعامة تعالج، وبنظرة متعالية، الشؤون الماورائية والكلية (الكونية) غافلة عن الشأن الإنساني المحض (الأنطولوجي)، باعتباره تفصيلاً غير “جوهري” من المنظور غير المادي
وحين أقبلَ العربُ على التفكر الفلسفي، بدءاً من القرن التاسع (الثالث للهجرة)، ينهلون من المعين اليوناني نفسه، ويُخرجهُ كل منهم على رؤيته الخاصة، رأوا إلى الفلسفة على أنها “النظر إلى الوجود الضروري” واعتبار “معرفة النفس” هي المآل الأول لهذا التفكير (ابن سينا). واعتبر آخرون أن الفلسفة هي اعتمادٌ على الفكر في التدبر الفعال في الأشياء المادية التي يصادفها الإنسان” (ابن رشد). ولعل الرأي الأخير لابن رشد هذا أقرب إلى الفهم الأنطولوجي المعاصر للفلسفة. في حين اعتبر البعض الآخر أن الفلسفة هي “علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، ما دام أن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق، وفي عمله عمل الحق” (الكندي).

كتاب “الفلسفة هي الحاية”
في الكتاب الصادر حديثاً (2024) عن دار روبير لافون، للفيلسوفة الفرنسية غابرييل بوزو دي بورغو، وعنوانه “الفلسفة هي الحياة” تقول في مقدمته، ما معناه أن بمقدور الفلسفة أن تضيء على حياتنا اليومية، مثلما أضاءت على حياتها الشخصية. وأن الفلسفة هي رفيقة درب سرية وبينة الوفاء، وأن في ما يرويه المرء، على ضوء الفلسفة، الكثير مما يلامس الإنساني الكوني. وأردفت لاحقاً ما مفاده أن فلسفتها اليومية تقتبس بعضاً من أنوار فلسفة جان بول سارتر (الوجودية)، وبعضاً من نظرات سيمون فايل الواقعية (الماركسية) والروحية من أجل تعليل مفاصل أساسية في حياتها (حياة الكاتبة)، و”فهمها وفهم العالم” من حولها، على ما ورد في عنوان الكتاب الفرعي.
ينقسم الكتاب ثمانية أقسام، تتولى الكاتبة معالجة أغلب جوانب شخصية المتفلسف، أي شخصية الكاتبة، وأهم التساؤلات العميقة التي يحسن بها مساءلة نفسها عنها، على ضوء الفلسفة المعاصرة، وعلم النفس، والتواصل، والأدب، وعلم الاجتماع، وغيرها من المراجع ذات الصلة. ومن هذه الأقسام، أنا والآخرون، والتفكير في الجسد، ومنْ يخشى من الموت؟، والالتزام النسوي، وأن تتألم الحيوانات أو لا، ونظراتنا وعمانا، وكنْ (كوني) ذاتك (ذاتكِ)، ومنْ تراها أنا؟
أنا والآخرون
في المقالة البحثية الأولى التي تصدر بها الكاتبة والفيلسوفة دي بورغو كتابها، تختار أن تعالج شأناً يخص وجود الكائن، وجودها في علاقتها العاطفية مع الآخر، والآخرين من خلاله. فتبدأ بإقرار مسلمة كونية بأن لا حياة للفرد من دون آخر، وآخرين. وأن وعيَ وجود الإنسان ذاته، هو إدراك لحدوده. مع اعتبار أن الآخر لا يمكن أن يكون نسخة طبق الأصل عن الذات، حتى لو ارتبط به ارتباطاً عاطفياً وجنسياً حميماً. وبناء عليه، تقول المؤلفة بورغو أنه من الخطأ الذوبان في الآخر؛ ولئن تكون ثمة درجة عليا من اضطرام المشاعر، في العلاقة الجنسية بين الطرفين بحيث يشعر كلاهما بتقارب كبير في المشاعر، ولا سيما إذا كان أحدهما يصغي إلى الآخر إصغاءَ المحب الملهوف، فإنه يتجاوز الحد المعقول إذ يظن بأن لا حياة داخلية لهذا الآخر، وأن الاختلاط والتماثل بين نفسيهما حاصل بلا ريب.

أن يفكر المرء في جسده (موقع فلسفة)
وتورد الكاتبة في هذا السبيل فيلماً بعنوان “أساسي”، للمخرج بيتر سوهن، يدور حول علاقة شخصين من طبيعتين متنافرتين؛ الطبيعة المائية/ والنارية، بحيث لا يجرؤ أحدهما على ملامسة الآخر مخافة التفاني. ويخلص الفيلم إلى ابتداع الحبيبين كيمياء خاصة بهما، تحول دون فنائهما الواحد في الآخر. أما الخلاصة الفلسفية من هذا المثل، فهي أن الآخر هو الذي يحدد ذاتي، على حد قول الفيلسوفة بورغو. على أن مضمون هذه الهوية ماثلٌ بين حدين، على قولة المناطقة، حد وجود الآخر، وأفكاره، ومحظوراته، ونظرياته، وأحواله المادية والروحية، والحد الثاني عدم قبوله هذه الأفكار تلقائياً، وما ينجم عن هذا الرفض.
أن يفكر المرء في جسده
ثم تعرج الكاتبة على موضوع، لا يستسيغه، في الغالب، المشدود إلى الماورائيات، وهو وعي المرء، أو المرأة، جسدها. وقد نفذت إليه الكاتبة من طريق السرد الأليف بين الأم وابنتها، إذ رأتها ازدادت سمنة عما كانت عليه، وصارت تقترح عليها أن تمارس رياضة كرة السلة. في حين راحت الفتاة، المثال المقترح، والكناية على كل امرئ مراقب لجسده، تنظر بحسرة إلى أجساد زميلاتها الخفيفة والنحيفة، وتفكر في ما تفكر فيه أمها وما تقترحه عليها من طرائق لتنحيف الجسم. ولما أيقنت، هذه الفتاة، أن جسدها هو ملكها، وليس للآخرين، أياً كانوا، الكلمة الفصل في شأن هذا الجسد، قررت أن ترد على هذه العروض بما يناسب جسدها وإرادتها وميولها. ومن هذا الباب تدخل الكاتبة إلى التأمل الفلسفي في الفوارق بين المرأة والرجل، في ما يتعلق برياضة كرة السلة وبغيرها. فتقول، استناداً إلى دراسة أجرتها الباحثة الأميركية ماريون يونغ، إن الفتاة أو الأنثى بعامة تستخدم يديها وحدهما لدى تداولها كرة السلة ودفعها عنها، وتبقى أسيرة الحيز المعطى لها في اللعبة. بينما يقوى الفتى والرجل بعامة على استخدام جسده كاملاً، والتصرف بكامل حيز اللعبة المكاني. فتخلص إلى أن المرأة محكومة، لدى تصرفها بجسدها، بالنظرة الذكورية إليها، وبالآراء المسبقة التي تشكل نسيج المجتمع مقابلها.
من لا يخشى الموت الشرير؟
في الفصل الثالث، تبدأ الكاتبة غابريال دي بورغو موضوعها بسرد واقعة من سيرتها الشخصية، وهو موت الجدة، مسجاة على السرير، والحزن يجتاح كيان أمها، على خلاف ما شهدته منذ وعت على الدنيا. والدموع تنهال على خدي الأم، ونحيب، يعقبه رثاء للميتة، وحدادٌ، واستطالة لحالة الصمت التي تعقب الفقدان، والتفكير في الفقيدة، معظم الأيام والليالي اللاحقة بالدفن. ولعل هذا ما لا ينفرد فيه امرؤ، على وجه البسيطة. ومن هنا تباشر الكاتبة التأمل المستفيض في ما يتركه الموت لدى منْ لا إيمانَ عنده بما وراءه، ولمن يؤمنون على السواء، من ندوبٍ وآثار وعواقب على كل صعيد. فلا تجد سبيلاً إلى التفكير المعمق في الموت، سوى باللجوء إلى الفلسفة. وعندها تجادل في ما إذا كان الموت شراً خالصاً، ينبغي تجنبه، أو إذا كان لا بد منه. فتستنتج أن الموت يكون شراً حين يأتي أبكر مما نتوقعه لامرئ أو لنا، أو لأحد الأقرباء أو الأحباء. ويكون لا بد منه لأن الحياة البشرية محدودة في الزمان والمكان، وهي ما دامت كذلك. وفي ما عدا هذا اليقين يدخل في باب التسرية عن الذات وتضييع الانتباه عن لحظة النهاية، أي الموت.
ولكن الكاتبة، وربما لسابق اعتبار فلسفي صارم في أن الموت ختام نهائي، لا رد فيه، لكل حياة مادية، على حد قول الفيلسوف إبيكور، أهملت تراثاً فنياً وأدبياً وهندسياً عظيم الثراء لشعوب وحضارات قديمة كانت قد ابتدعته ليكون مادة لخلود ملوكها، ودوام ذكر عظمائها على مر الأعوام والعصور. ثم أليس الفن والأدب والإبداع بعامة محاولات للتعويض عن نهاية المرء المحتومة بالموت، وتجاوزاً له ببقاء آثاره بديلاً عن حضوره المادي عبر الزمن؟
وأياً يكن الأمر، فإن التفكر الفلسفي الذي لجأت إليه الكاتبة كان كفيلاً بالكشف عن أبعاد هذه المعضلة البشرية، عنيت بها الموت، وإعادة النظر في السلوكيات غير المتناظرة حياله، بين الرجل والمرأة، بين المفكر والفنان والأديب، وبين الكائن المهمش والفقير والمشرد والعرضة للقتل أو الظلم أو غيره.
في الفصل الخامس من الكتاب، روت الكاتبة، أول الأمر، كيف كانت لاحمة، وتستهلك كغيرها لحوم الدواجن والمواشي، ولا سيما الابقار منها، ثم كيف تحولت إلى نباتية، بفضل وعيها مقدار العذاب والآلام التي تُسام بها الحيوانات هذه أوان ذبحها، وتقطيعها، وتمريرها للمستهلكين في العالم طعاماً لهم، معداً بلا رحمة. وتورد في هذا الشأن إحصاء بأعداد الطيور الداجنة التي تربى بظروف مدعاة للتقزز، وبأعداد الأبقار التي تُساق إلى الذبح وهي تملأ الفضاء عويلاً وبكاء بلا أي طائل، على حد تعبيرها. وتقول إن ذلك الألم، يزاد إليه الضرر البيئي الكبير الناجم عن الانبعاثات المؤذية للغلاف الجوي، كانا كفيلين بتحويل ميلها الغذائي نهائياً، فصارت نباتية ومناضلة بيئية في الآن نفسه. وبالطبع، فإن الكاتبة والفيلسوفة، حالما تتثبت من صحة استخلاصها، تصير ملتزمة روحاً وعملاً بما باتت على يقين به. ومنذئذ، لم تعد تذوق اللحوم أياً كان مصدرها الحيواني، وأخذت على عاتقها التصدي للعادات الاستهلاكية التي تستطيبها الغالبية من البشر، من دونها. ذلك أن الفيلسوف (ة) بحسبها، هو ابن (ة) يقينه المبني على تفكير منهجي سليم، تؤيده الدراسات الميدانية التي تقوم بها الجمعيات العلمية ذات التوجه البيئي الأخضر.
في العنصرية
تستهل الكاتبة دي بورغو الفصل السادس بهذا العنوان أعلاه، برواية معاناة شخصيتين هما تومي آيديمي الأفريقية الأميركية من أصول نيجرية وصبا طاهر الباكستانية الأميركية وهما تبحثان عمن يشبههما في أخبارهما، وفي سعيهما إلى نيل القبول من المجتمع الأميركي “الأبيض”. ولا تلبث أن تعرج على روايات هاري بوتر الشهيرة، فلا تجد أياً من شخصياتها سوداء أو آسيوية، ولا ينتاب مؤلفتها، جوان كاثلين رولينغ (1965) أي شعور بالانتقاص من أي كان. ثم تمضي، وفقاً لمنهج التداعي، إلى ذكر حادثة مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد عام 2020، على يد شرطي أميركي أبيض، لتقول إن العمى العنصري لا يزال حائلاً، لدى الغربيين، أميركيين وأوروبيين، من دون النظر الصحيح إلى الآخرين، من الشعوب الوافدة إلى القارتين، أو المحكومين بساسة من قبيلهم بلا بعد نظر أو تدبير عصري للدولة ومواطنيها. وبذلك تُزاد نظرتها النقدية إلى عنصرية الغرب، على كل من أشار إليها من الفلاسفة والإصلاحيين، أمثال فرانز فانون، ومايكل سكوت وغيرهما.
في الأصالة والهوية
في الفصلين الأخيرين، أي السابع والثامن تعالج الكاتبة والفيلسوفة غابرييل بوزو دي بورغو، مسألتين من منظور فلسفي صارم، بالعودة إلى فكر بول ريكور، وجان بول سارتر، وغيرهما، لتقول إن التزام المفكر والناظر في نفسه وفي الآخرين هو مسؤولية تُلقى على عاتقه، وتلزمه مواصلة جهوده للكشف عن مواطن الخلل في شخصيته المعاصرة، تصويباً لها. ثم إن الحرية التي أُعطيت للمفكر الملتزم، لا تطلق يديه كلياً في كل الأمور، ما دامت قيود المكان والزمان، والصحة، والوضع الاجتماعي، والظروف العائلية، تحول دون تحقيق مرتجاه. فإذا أمكن الشخص أن يحقق بعضاً من مثالاته، وهو يقاوم كل التحديات التي تحيط به، فهو حتماً بلغ مقام الأصالة المنشودة.
أما الهوية، وهي على ما بنته من أمثلة في الرواية المعاصرة، ومن فكر بول ريكور، على السواء، فهي تلك المتحصلة من الهوية السردية، أي من خلاصة تجارب الكائن، عبر مراحل حياته، وما خبره فيها، وليس بناء على الانتماء المسبق، أو التصنيفات الاجتماعية التقليدية.
وأياً يكن الأمر، فإن الكتاب للمفكرة غابرييل بوزو دي بورغو، يشكل دعوة مبسطة ومعقولة، للقراء إلى المباشرة في التفكر في الذات والآخرين، تفكراً منطقياً، ومنهجياً، ولا بأس أن يكون تفكراً فلسفياً يفيد المتفكر بصوت عالٍ، ويتيح كشفاً لصورة الآخر والآخرين، بغاية إصلاحهما أو ترميمهما، أو بغاية أخذ العلم ليس إلا.