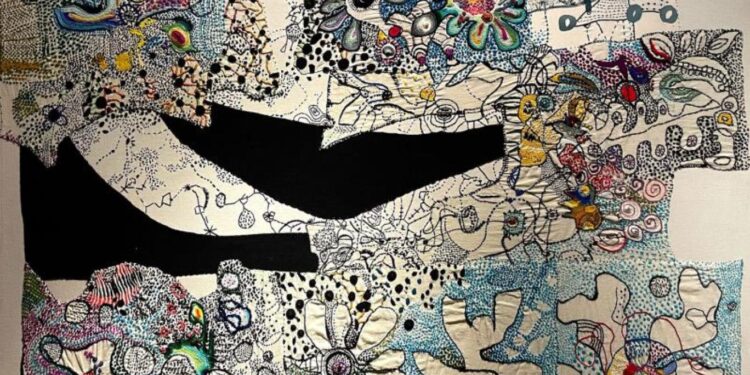حرية – (2/6/2024)
يدخل محمد الأشعري في ديوانه الجديد “جدران مائلة” (منشورات المتوسط) القارئ إلى مساحات الكتابة، ويفتح له باب التخييل من أجل ملء الفراغات التي تركها الشاعر، وهو يقفز بكل خفة شعرية بين لحظات كثيرة من عمره، ويقفز أيضاً على لحظات أكثر، تاركاً مهمة تشكيلها للقارئ. يكتب لنا الأشعري القليل مما عاشه، ويخفي عنا الكثير، وهذا هو الفارق الأساس بين الكتابة السردية والكتابة الشعرية. فإذا كانت مهمة السارد هي التعمق في تصوير التفاصيل، فإن إبداعية النص الشعري تقوم على التكثيف والإيماء. يبذل السارد جهداً لإظهار المعنى، ويبذل الشاعر الجهد نفسه لإخفائه.
قسم الأشعري نصه الأول “يوميات شخص ينهض باكراً من دون أن يستفيق” إلى 19 مقطعاً، ينطلق في المقطع الافتتاحي من الراهن، ليعود بعده إلى ماض مركب ومتراكم. يوحي المشهد الأول بما يشبه التراخي والخمول الذي يطبع نظام حياة نأت عن شبابها. ثمة تذمر من التفاوت الصارخ بين إيقاع الزمن والإيقاع الذي تسير به حياة الشاعر: “لكن النهار يمشي سريعاً/ بمعطفه الثقيل/ بينما أنا/ أتضاءل باستمرار/ رغم عبير القهوة/ والبلابل التي سقطت كندف الثلج/ على شجرتي الميتة”.

كتاب محمد الأشعري
يقطع الشاعر سريعاً مع هذه اللحظة المفعمة برماد الزمن، ليعود إلى الشعلة الأولى، وإلى حالات التوهج. فيستهل المقطع الثاني بتصوير لحظة الولادة، لحظة خروج الشاعر من دفء الرحم إلى برد الوجود. فقد جاء إلى العالم في صباح شتوي قديم ليجد نفسه في جغرافيا سمتها الأولى والأخيرة هي الهشاشة. تتقدم النصوص الاستعادية صورة الطفل الذي يمشي في الطرق الزراعية بقدمين متشققتين، وهو يحمل في ذاكرته مشاهد أولى أججت علاقته بالعالم الذي جاء إليه: مصرع امرأة وقعت في بئر، وموت أشخاص آخرين “ابتلعتهم الأرض/ من دون حرب/ ولا مصارعة/ ولا ثأر بارد”.
معجم رعوي
يشير الشاعر إلى أن هاجس الكتابة استبد به منذ الطفولة، طفولة الحبر والريشة حيث اللغة “كلمات مالحة”، لا يتحقق فيها المعنى إلا بـ”الحفر في اليابسة”. لعلها كانت طفولة عسيرة تلك التي صورها لنا الشاعر بمفردات تحمل دلالتها عارية من دون الحاجة إلى تفسير أو ترجمة: الخوف والمراثي والعوز والصبر ودمعة واحدة وبكاء حاد وطوفان وبراكين وهلاك وأحزان رقيقة ومراكب ميتة. إن هذه القسوة اللغوية تستمد مشروعيتها من قسوة سابقة في الحياة، لذلك شبه الشاعر الخروج من الطفولة إلى اليفاع بالنزول من الهضبة إلى النهر، بما تحمله الهضبة من دلالات عناء الصعود وبما يحمله النهر من دلالات الانسياب.

الشاعر محمد الاشعري
تحضر الهجرة خلال مرحلة الشباب في “جدران مائلة” بأوجه متعددة، ليس أولها الرغبة في الانزياح عن المكان الأول، وليس آخرها الخوف من المجهول. لقد كان الخروج من مسقط الرأس عبثياً أيضاً، ويكفي أن الوسيلة كانت “شاحنة فورد حمراء” ركبها الشاعر “مع البهائم والشياطين”. يصور الشاعر خروجه من المكان الأول داخل إطار من المباغتة: “اقتلعتني الريح/ مثل أطرش في العاصفة”. ويصور لاحقاً عودته، عبر قطار المسافات الطويلة، إلى المكان الأول في العطلة الكبيرة “محمولاً على صيحات الأطفال”.
يحضر المعجم الرعوي في الجزء الأول من الكتاب تناغماً مع محيط الطفولة القروية: قطعان والحقول والأشجار وأعشاش ونخلة وطين والثعابين الحريرية والتوت البري والبهائم وجبل والهضبة والقرية والعصافير وفزاعة وأحصنة برية. إن عناصر الطفولة في نصوص الأشعري تحولت من مواد مرئية إلى رموز مخزنة في الذاكرة، إلى “فردوس داخلي” كما صورها لنا الشاعر. لذلك فهو يحلم باستمرار بأن يفاجئه النهر “بمرور دامع/ يعيد المعنى/ لهذه الضفاف المهجورة”.
قسوة المدينة
يسرد الشاعر تفاصيل من حياته في المدينة المخيفة، إذ “عنف آخر الليل” وقسوة الوجوه والأمكنة “جربت النوم في مواقف الباصات/ والسهرات الفخمة/ والحب في سيارات العجائز/ جربت الانتظار الصبور/ وكان أسوأ شيء/ في المغامرة/ ثم أدركت أخيراً/ أن المرأة الموعودة ليست هنا”. وبتغير فضاء السرد تتغير المفردات التي توسلها الشاعر وهو يصور المشاهد المرتبطة بفضاءات المدينة: مصابيح، شوارع، باصات، محطة، سهرات، صخب، مواعيد، سفينة، حديقة.
كان الوصول من القرية إلى المدينة مفعماً بالدموع. هذا ما ينقله لنا الشاعر في نص مطول بعنوان “كتاب الفقر”، مصوراً لنا مشاهد لا تخلو من حس كاريكاتيري، إذ الحذاء الذي “انتعلته من دون جوارب/ ومن دون خيوط/ وتعذبت حتى تآلف/ مع قدمي الكبيرتين”. ربما تخفف الشاعر من البلاغة لأن الصورة في حد ذاتها بليغة.
يبدو نص “كتاب البتر” بمثابة اعتذار للحب الأول، في هذا النص اللافت يتغير مستوى الخطاب وآلياته، إذ يتجلى الشاعر بالرقة والحنو والتدفق في ابتكار صور شعرية أخاذة تنقل إلى القارئ حرارة ما يعتمل في ذاته.
يحاول الشاعر عبر هذا النص أن يكفر عن ذنب قدي: “لقد تركتك هناك/ أعرف ما فعلت، أعرف أني أرسم قيامة كبرى/ لأخبئ فيها جبني/ ماذا سأقول للكلمة الأولى/ التي ستطاردني بشراسة ذئبة فقدت صغارها؟” يختم الشاعر جدرانه المائلة بـ”كتاب المراثي”، ربما لأن الرثاء مديح متأخر كما كان يقول محمود درويش، وهو بهذه الخاتمة المريية يذكرنا بأن كل لحظة تؤول إلى الموت، نكهة الوجود كما كان يسميه سيوران.
التحذير من الفاجعة
يحاول الأشعري أن ينقل عالمه وما عاشه في هذا العالم من خارج النص إلى داخله، وهو يؤمن بأن كل ما يقع في الخارج يمكن أن يكون عنصراً داخل النص، قاطعاً بذلك مع كل نظرية تقوم على مبدأ التقسيم بين ما تحتمله لغة الشعر وما لا تحتمله أو بين مفردة معدة للشعر وأخرى مبعدة عنه. ألم يقل جوزيف كونراد: “إن الشعر هو العالم وقد تحول إلى اللغة؟”.
لم يعد غريباً أن يحضر السرد في الشعر، ويشكل أحد عناصره البنائية الكبرى، لقد كان رولان بارت يرى أن كل مادة تصلح لأن تتضمن سرداً، بما في ذلك الصور الجامدة. بالتالي فقد بات متجاوزاً سؤال تداخل الأجناس، وصار السؤال الأكثر جدية هو: ماذا سيفعل الشاعر بالسرد؟ كما لو أننا نسأل: ماذا سيفعل الخزاف بالطين؟ ونحن نبحث عن قدرة الخزاف على إبداع تحف أخاذة نبحث في الآن ذاته عن مدى قدرة الشاعر على إدهاشنا، بغض الطرف عن خياراته الشكلية والجمالية.
تنتعش كتابة الأشعري في ظل تراجع نظريات الأنواع الأدبية، لكننا أمام عمل شعري متناغم، لم يكن فيه السرد إلا حيلة من أجل نقل خطاب عميق يشغل الشاعر ويملأ ذاته على نحو يجعل تدفقه إلى الخارج ضرورة. من نص إلى آخر، وفي غمرة محكياته، يقف الشاعر متأملاً ما يحيط به، متوجساً مما سيأتي. فالعنوان “جدران مائلة” يحيل على السقوط الوشيك، على الخوف من النهايات المرعبة. فكل جدار مائل مآله الانهيار، لعله انهيار إنساني أو نفسي فردي أو جماعي. لذلك فوظيفة الشاعر ليست فحسب أن ينتظر هذا الانهيار ويكون شاهداً عليه، بل وظيفته الأساس هي تنبيهنا وتحذيرنا من الفاجعة المقبلة.