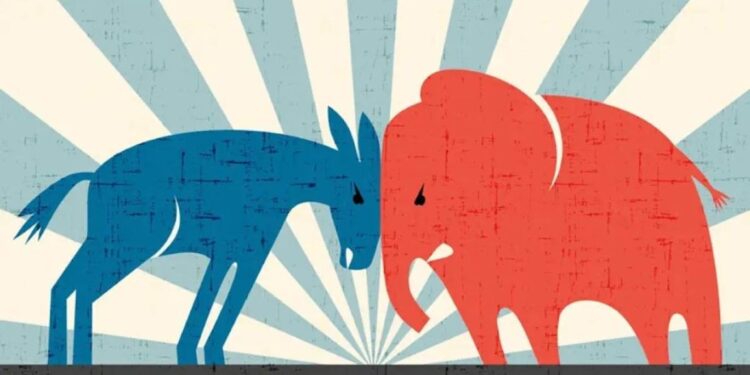حرية – (11/8/2024)
حين تقدم رجل العقارات الشهير دونالد ترمب من دائرة السباق الانتخابي الأميركي عام 2016 كان في واقع الأمر بعيداً كل البعد من دائرة العمل السياسي والحزبي.
ويتساءل القارئ: كيف وجد الرجل طريقه إلى الترشح للرئاسة وهو رقيق الحال بهذه النوعية من العمل، وكيف له أن تمضي به المقادير ليحصل على ترشيح الحزب الجمهوري؟
عرف الملياردير الأميركي وقتها أنه ما من درب إلى البيت الأبيض سوى أحد الحزبين الكبيرين، ولأن ميوله محافظة يمينية بصورة أو بأخرى، لذا وجد ذاته في قلب الحزب الجمهوري.
هل نذيع سراً إن قلنا إن الجمهوريين في ذلك الوقت، لم يكونوا مفضلين لترمب؟
بالقطع بدا الأمر على ذلك النحو بالفعل، غير أن حضور ترمب القوي، بملياراته الوفيرة، وداعميه بالملايين، وضعوا الحزب الجمهوري في مأزق، لا سيما بعدما هدد بالترشح مستقلاً، ما بدا وكأنه خسارة مؤكدة لهم، في مواجهة هيلاري كلينتون الضاربة جذورها في العمل العام منذ وقت طويل.
هنا بدأت قطاعات واسعة من الأميركيين التساؤل: هل حان الوقت لطريق ثالث، حزب ثالث مغاير للأوضاع الحزبية الأميركية التقليدية، التي هيمنت على المشهد السياسي الأميركي في الـ150 عاماً الماضية؟
جاء الجواب عبر صناديق الاقتراع التي رشحت ترمب لأن يكون سيد البيت الأبيض القادم من خارج المؤسسة السياسية الحزبية التقليدية.
كانت الدلالة المباشرة هي أن الجماهير قد سئمت من الثنائية الحزبية التي لوثتها على نحو كبير مظاهر الفساد السياسي، وباتت عرضة للشراء على نواصي الطرقات.
هل كانت هذه بداية المطالبات بحزب ثالث يفتح مجالات للمستقلين ولأصحاب الرؤى التقدمية في الداخل الأميركي، وخلافاً لكل ما هو موصوف ومعروف ومألوف؟
ربما يجب علينا العودة إلى التاريخ البعيد، أي بدايات تأسيس أميركا، والتساؤل عن أزمنة نشأة الحياة الحزبية، وهل كانت الفكرة في حد ذاتها، أي نشوء وارتقاء الأحزاب، أمراً مرحباً به، أم محذراً منه؟

جيمس ماديسون من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة
خوف مبكر من نشوء الأحزاب
مبكراً حذر جيمس ماديسون، أحد الآباء المؤسسين، والذي سيضحى الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأميركية، وينسب إليه الفضل في اقتراح الإطار الرئيس للدستور، في الورقة الفيدرالية رقم 10 التي كتبها عام 1787 لإقناع مواطني نيويورك بالتصديق على الدستور الفيدرالي الجديد، قراءه من شرور الطوائف، أي الأحزاب بالمفهوم اللاحق، تلك التي وصفها بأنها “تتعارض مع حقوق المواطنين الآخرين ومع مصالح المجتمع الدائمة والكلية”، كما حذر جورج واشنطن في خطبة الوداع التي وجهها للأمة لدى رحيله عن سدة الرئاسة “بكل جدية من الآثار الوبيلة للعصبية الحزبية”.
ومع ذلك، فإن ماديسون هو الذي حث توماس جيفرسون الذي سيشغل منصب الرئيس الثالث للبلاد على المشاركة في تنظيم ضد سياسات ألكسندر هاملتون وزير خزانة واشنطن وكاتب خطبة الوداع الشهير.
ولعله من قبيل المفارقات والمتناقضات أن صار مؤسسو الأمة هؤلاء الذين كانوا يخشون الطوائف وجادلوا ضد الأحزاب السياسية، زعماء أولى الأحزاب نشأة، إذ كان الحزب الديمقراطي – الجمهوري الجيفرسوني أول حزب سياسي جديد.
لم تكن المؤسسة التي خشيها المؤسسون قد تطورت فعلاً وقت تلك التحذيرات، لكن أحزاباً ونظاماً ثنائياً تطور بالفعل في وقت مبكر من التاريخ الأميركي واستمر منذ ذلك الحين.
ولعله من المؤكد أنه منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2000، بدأ بعض الأميركيين يشككون في فعالية نظام المجمع الانتخابي، كما شكك ملايين الأميركيين في النظام السياسي الذي سمح للديمقراطيين والجمهوريين بالهيمنة على أحوال ومآلات السياسة الأميركية لنحو 150 سنة، وباتت هناك شكوك كثيرة حول بقاء حزبين فحسب، يمكنهما المنافسة ملياً على السلطة.
ولعله من نافلة القول أن النظام الانتخابي الرئاسي الأميركي يوصف بأنه نظام ثنائي الحزبية، لكن المؤكد جداً أن الأحزاب السياسية غير مذكورة بالكلية في الدستور، ولا توجد قوانين تفرض التنافس في الانتخابات بين الديمقراطيين والجمهوريين، كما يخوض متسابقو الأحزاب الصغيرة أو المستقلون الانتخابات على مناصب كثيرة في كل دورة انتخابية.
لكن هناك حزبين يهيمنان فعلاً على السياسة الأميركية، وطوال العقدين الأخيرين، وفي الوسط من 535 مشرعاً، غالباً لا يوجد سوى عضوين من غير الديمقراطيين أو الجمهوريين.
فهل باتت هذه الحدية الحزبية الثنائية في الداخل الأميركي، محل مطالبات جذرية بتغيير لا بد منه في القريب، وربما على مشارف الانتخابات الرئاسية القادمة 2028؟

جورج واشنطن
كيف ينظر الأميركيون إلى أحزابهم؟
عبر مراجعة معمقة لعديد من الأوراق الصادرة عن مركز “بيو” للأبحاث في واشنطن، يخلص القارئ إلى أن غالبية الأميركيين ينظرون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري بصورة سلبية، وفي حين يقول غالب البالغين إنهم يشعرون بأنهم ممثلون بصورة جيدة ما من قبل أحد الحزبين في الأقل، فإن ربعهم (25 في المئة) يقولون إن أياً من الحزبين لا يمثل مصالح أشخاص مثلهم بصورة جيدة إلى حد ما.
هنا وفي ظل عدم الرضا عن الأحزاب السياسية، حتى بين الموالين للحزب، لا يزال عديد من الأميركيين منفتحين على إمكانية وجود مزيد من الأحزاب السياسية. ومن المرجح بصورة خاصة أن يعبر الشباب وأولئك الذين لديهم ارتباطات حزبية فضفاضة عن رغبتهم في وجود مزيد من الأحزاب.
وبشيء من التفصيل نجد في أرقام “بيو” ما يفيد بأن حراكاً سياسياً أميركياً، يسعى بالفعل لتغيير الواقع الحزبي الثنائي المحتقن، إن جاز التعبير.
من بين جميع البالغين في الولايات المتحدة يقول 37في المئة إن عبارة “أتمنى لو كان هناك مزيد من الأحزاب السياسية للاختيار من بينها”، تصف وجهات نظرهم بصورة جيدة للغاية. ويقول 31 في المئة آخرون إنها تصف مشاعرهم بصورة جيدة إلى حد ما.
هل يعني ذلك أن وجود حزب ثالث يمكن أن يغير من حالة القلق السياسي المسيطرة على الداخل الأميركي في العقدين الأخيرين بنوع خاص؟
الشاهد والمثير أن الأرقام تؤشر إلى ما هو مغاير، إذ لا ينظر إلى وجود أحزاب إضافية باعتبارها حلاً واعداً للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد، إذ يرى نحو ربع الأميركيين تقريباً فحسب، أن وجود أكثر من حزبين رئيسين من شأنه أن يسهل حل مشكلات البلاد، وتقول نسبة مماثلة إن ذلك من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.
فيما يعتقد ثلثهم فقط أنه من المرجح أن يفوز مرشح مستقل بالبيت الأبيض في السنوات الـ25 المقبلة، بينما يرى 66 في المئة أن هذا الاحتمال غير وارد إلى حد ما.
هل يحاصص الأميركيون كثيراً بين الحزبين الكبيرين في البلاد، الجمهوري والديمقراطي؟
تقول غالبية ضئيلة من الأميركيين (54 في المئة) إن هناك قدراً كبيراً من الاختلاف بين ما يمثله الحزبان الجمهوري والديمقراطي. ويقول 35 في المئة آخرون إن هناك قدراً كبيراً من الاختلاف في القيم، في حين يقول 10 في المئة فقط إن الاختلاف بين الحزبين ضئيل للغاية.
هل تعني هذه الأرقام في مجملها أن معدلات الثقة في الحزبين الكبيرين الحاكمين، تظهر حاجة فعلية لحزب ثالث يغير الأوضاع ويبدل الطباع؟

أندرو يونغ
حديث الطرف الثالث
من الواضح أن الحديث عن الحزب الثالث قد تجاوز بالفعل مرحلة التنظير، ولو على سبيل التجربة، فقد شهدت الأشهر الأولى من العام الحالي تجربة مجموعة وسطية سعت إلى جلب منظور معتدل إلى المناقشات السياسية، وباتت تعمل الآن أكثر مثل حزب سياسي، وقد حملت شعاراً مثيراً “لا شعارات”.
بدا واضحاً أن هناك تياراً حقيقياً يسعى على الأرض لجمع الأموال لهذا الطرف الثالث، والذي وجد في خزينته قرابة 70 مليون دولار سعياً للحصول على حق الوصول إلى صناديق الاقتراع.
ولعله من المدهش أن هذا التيار قد أتى ثماره بصورة سريعة، إذ وصل إلى خط الاقتراع الرئاسي لعام 2024، في أربع ولايات غربية حتى نهايات أبريل (نيسان) الماضي، هي آلاسكا وأريزونا وكولودرادو وأوريغون.
هل يعني ذلك أن شهية الأميركيين باتت مفتوحة بالفعل لحزب ثالث؟
في استطلاع لمؤسسة غالوب في الخريف الماضي 2023 ظهر أن غالبية الأميركيين يتفقون على أن الديمقراطيين والجمهوريين يؤدون عملاً سيئاً للغاية لدرجة أن هناك حاجة إلى حزب رئيس ثالث.
في هذا الإطار، صرح أندرو يانغ، المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة ورئيس بلدية مدينة نيويورك الذي أسس حزب Forward Party عام 2021 بأنه مع عيش معظم الأميركيين في ولايات يهيمن عليها الديمقرطيون أو الحزب الجمهوري، فإن الحزبين الرئيسين يحتاجان إلى القليل من “المنافسة الصحية”. وأضاف “الثنائية الحزبية تتآكل”، وقد جاءت هذه الكلمات المثيرة خلال ما عرف بقمة “حالة أميركا” التي عقدها مركز “واي” في شارع 92 في نيويورك خريف 2022. على أن المشهد لا يستقيم بالمطلق بالنسبة لفكرة مرشح حزب ثالث يمضي نحو البيت الأبيض، ذلك أنه إذا كان المواطنون على استعداد لإخبار خبراء استطلاعات الرأي بأنهم يريدون حزباً ثالثاً، إلا أنهم نادراً ما يكونون على استعداد للتصويت لصالحه.
على سبيل المثال عام 2016، عندما تضمنت الانتخابات اثنين من أقل المرشحين الرئيسين شعبية، أيدت النسبة الساحقة من الناخبين أحدهما، كما يلاحظ سيث ماسكيت، عالم السياسة بجامعة دنفر. يقول ماسكيت “حتى مرشح حزب ثالث محترم مثل غاري جونسون لم يجمع أكثر من ثلاثة في المئة من الأصوات.
والثابت أنه في وقت شديد الاستقطاب، عندما يخشى الناس أكثر من أي شيء تقريباً أن يفوز مرشح من الحزب الآخر، أصبحت فكرة أن مرشحي الحزب الصغير لا يمكنهم إلا أن يعملوا كمفسدين، راسخة بعمق، وبات من المسلم به أن بعض ذلك عبارة عن رسائل أنانية من الحزبين الرئيسين اللذين لا يحبان أي شيء يتحدى احتكارهما الثنائي.
التحليل المتقدم يدفعنا في طريق التساؤل الجدي: هل النظام الحزبي الحالي يدفع الأميركيين إلى الاختيار بين خيارين يمينيين؟

ريتشارد نيكسون
خيارات يمينية ورؤى ثالثية حزبية
من بين أعلى وأهم الأصوات التي تناولت قضية الحزب الثالث في عالم السياسة الأميركية البروفيسور دونالد كولينز المحاضر الجامعي في الجامعة الأميركية بواشنطن العاصمة، وعنده أن الأشهر القليلة الماضية، التي امتلأت فيها العاصمة الأميركية واشنطن بالاحتجاجات الطلابية ضد حرب إسرائيل على غزة، والطريقة التي قمعتها بها السلطات، قد كشفت عن أن الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى حزب ثالث قابل للحياة من اليسار إلى يسار الوسط وملتزم بالديمقراطية.
يعتقد كولينز جازماً أن المشكلة لم تعد تقتصر على الجمهوريين واحتضانهم العلني لما يسميه “الفاشية”، فقد أوضح رد فعل الرئيس بايدن وغيره من الديمقراطيين البارزين على الاحتجاجات الطلابية أن الحزب الذي يفترض أنه يمثل اليسار في أميركا هذه الأيام يميل إلى اليمين، ولديه كذلك انحراف واضح وفاضح ضد الديمقراطية.
هل الديمقراطيون إذاً متهمون بالميل إلى اليمين وليس الجمهوريين فحسب؟
تبدو هناك دلالات كثيرة في هذا السياق، منها على سبيل المثال وصفهم لما جرى في جامعة كولومبيا، والذي لم يكن خاطئاً فحسب، بل بدا وكأن كلماتهم مأخوذة من “خطاب الأقلية الصامتة”، الشهير الذي ألقاه ريتشارد نيكسون عام 1968، وفيه قال “عندما تعاني الأمة ذات أعظم تقاليد حكم القانون من انعدام القانون غير المسبوق، وعندما لا يستطيع رئيس الولايات المتحدة السفر إلى الخارج أو إلى أية مدينة رئيسة في الداخل دون خوف من تظاهرة معادية، فهذا يعني أن الوقت قد حان الأوان لقيادة جديدة للولايات المتحدة الأميركية”.
من هنا يمكن القطع بأن الديمقراطيين اليوم يبدون مثل الجمهوريين في الماضي، لسبب بسيط: لقد تحرك الحزبين بصورة كبيرة نحو اليمين في السنوات الخمس الماضية.
في الواقع، إنه منذ عهد نيكسون في السلطة، دفعت الإدارات من كلا الحزبين إلى سن قوانين وسياسات تحابي الشركات على حساب العمال، وخلق الظروف التي تسمح “للأموال السوداء” بتشكيل السياسة الأميركية والهيمنة عليها. وقد سمحت هذه الإدارات للشركات الكبرى والمليارديرات بتجنب دفع حصتهم العادلة من الضرائب، مما أدى إلى تعميق التفاوت وتعزيز الانقسامات المجتمعية.
هل يعني ذلك أن الديمقراطية الأميركية في أزمة؟

الرئيس الأميركي توماس جيفرسون
حزب وسطي هل ينقذ أميركا؟
تتعالى الأصوات، لا سيما هذه الأيام، إذ يعد كثير أن أميركا تعيش 100 يوم من الفوضى، منادية بإحداث حالة من التصحيح الحتمي في سياق الحياة الحزبية، وبات السؤال المطروح: هل ينقذ نظام التعدد الحزبي الديمقراطية الأميركية؟
الرد السريع عند جون ألدرتش المتخصص في مجال العلوم السياسية البارز في جامعة ديوك بولاية كارولاينا الشمالية هو أن الديمقراطية الأميركية في أزمة. من الحكومة إلى المواطنين، إذ يشكل الاستقطاب الحزبي أحد الأسباب الرئيسة لهذه الأزمة، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد أصبح أعضاء الكونغرس أكثر انقساما على أساس الحزب، وأكثر انقساماً على أساس السياسة من أي وقت مضى، بل وحتى أكثر من العصر الذهبي.
يقطع الرجل بأن فكرة النظام السياسي المتعدد الأحزاب في الولايات المتحدة بعيدة المنال، فقد تطور النظام الحزبي على مدى القرنين الماضيين حول وجود حزبين فحسب، فيما عديد من الديمقراطيات الكبرى الأخرى هي أنظمة متعددة الأحزاب حقاً، إذ تختار ائتلافات المشرعين بعد الانتخابات رئيس الوزراء وتشكل حكومة حاكمة.
هل يمكن أن يصل الأميركيون إلى مثل هذا النظام؟
يقطع المنظرون السياسيون بأن الأمر في هذه الحالة يحتم تخفيض مرتبة مجلس الشيوخ إلى مرتبة أدنى من مجلس النواب أو العكس، بالتالي جعل الحكومة الأميركية المنقسمة، وربما المتعثرة، غير ذات جدوى، وسوف تكون هناك حاجة إلى عديد من الإصلاحات الأخرى، مثل التصويت النسبي، إلى جانب فترة طويلة من التعديل.
هنا يطفو على السطح التساؤل المهم: هل يساعد الحزب الوسطي في الحد من التطرف المتزايد في الكونغرس؟
يميل تيار كبير من الشباب الأميركي إلى فكرة إحداث توازنات جديدة على صعيد الحياة السياسية الأميركية، ومن بينها إقامة نظام ثلاثي الأحزاب يتألف من الجمهوريين والديمقراطيين، إذ من المرجح أن تكون هذه الوصفة مجرد حجر الأساس نحو نظام ثنائي الحزبية جديد وأقل تطرفاً.
ولعل تعميق هذا الطرح سياسياً، يكشف لنا عن حقيقة ترك التطرف المتزايد للحزبين، مساحة في الوسط مفتوحة على مصراعيها داخل الكونغرس.
وعلى رغم وجود عدد قليل من الوسطيين في الكونغرس اليوم، فإن الجزء الأكبر من الناخبين لا يزال هناك. بالتالي قد ينجح المرشحون الوسطيون في الانتخابات العامة الحالية القائمة على التعددية.
هل يمكن أن يكون الحزب الوسطي الثالث هذا هو الطريق لانتشال الولايات المتحدة من حالة التشظي والانقسام السياسي والتهجم الحزبي، ناهيك بتشويه سمة أنصار الحزب المعارض الخارج الحكم؟
مؤكد جداً أنه وعلى مدى السنوات الـ50 الماضية، شهدت السياسة الأميركية انقساماً حزبياً متزايداً بين الحزبين الرئيسين، وفي الوقت نفسه يحدد المسؤولون المنتخبون من هذين الحزبين قواعد انتخاباتهم بأنفسهم. وإذا ما تركوا لتصرفاتهم الخاصة، فقد بنوا نظاماً يحمي أولئك الذين يشغلون مناصبهم بدلاً من الحكم وفقاً لإرادة الشعب.
وعليه يمكن القطع بأن الوضع الحالي الذي تعيشه الولايات المتحدة الأميركية، هو النتيجة الحتمية لنظام الحزبين، وسوف يؤدي هذا النظام إلى تعزيز قوة الحزبين على رغم اعتراضات الناخبين، مما يعني أن الحل الوحيد هو تزويد الأحزاب الجديدة بمسار انتخابي مغاير، حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد.

أبراهام لينكولن
الكلية الانتخابية عائق في الطريق
ولكي تكتمل الصورة، فإنه لا يمكن أبداً الحديث عن خيار ثالث أو حزب ثالث في الداخل الأميركي، من غير التوقف أمام طريقة انتخاب الرئيس والمعروفة بالكلية الانتخابية أو المجمع الانتخابي، والتي هي فكرة غير ديمقراطية في أصلها وجذورها، إذ إن المندوبين في الولايات هم الذين ينوبون عن الشعب، بمعنى أن مرشحاً ما يمكنه الحصول على غالبية الأصوات الشعبية، ويخسر مندوبيه ويفقد طريقه إلى البيت الأبيض. ويعني وجود الهيئة الانتخابية أن الفوز بالتصويت الشعبي لا يكفي لمرشح حزب ثالث للفوز بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يشجع المرشحين المحتملين على أن يصبحوا مرشحين ليس كمرشحين مستقلين، بل إما كمنتمين إلى الحزب الديمقراطي أو الجمهوري.
أنشئت الهيئة الانتخابية في الدستور الأميركي كحل وسط بين انتخاب الرئيس بتصويت في الكونغرس وانتخاب الرئيس بتصويت شعبي.
هل يضع هذا النظام عائقاً كبيراً، وربما خطراً على مسألة نشوء وارتقاء حزب سياسي جديد؟
غالب الظن أن ذلك كذلك… ما الذي يتبقى في هذا الحديث؟
ربما يتغير المشهد السياسي الأميركي طولاً وعرضاً، شكلاً وموضوعاً بعد انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
قد يجد الأميركيون أنفسهم أمام أوضاع سياسية وحزبية غير مسبوقة منذ زمن الاستقلال.
واشنطن قد تنتظرها عاصفة غير مسبوقة، بكل ما تعنيه الكلمة من محددات، فقد يصحو الأميركيون نهار السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على حكومتين ورئاستين، حكومة ظل ورئاسة ظل، وهو أمر متوقع حال رفض أحد الحزبين نتائج الانتخابات.
هنا لن تضحى الإشكالية موصولة فقط بالأحزاب وتعدديتها، بل ربما تتجاوزها إلى الدستور وبنوده وتعديلاته، وإلى الكونغرس ومكانته، والرئاسة ومستقبلها.
أبعد من ذلك يقول الراوي إن انتخابات عام 2024، ربما تكون المسمار الأول الذي سيدق في نعش النظام الفيدرالي، وأول ضربة قاصمة منذ نهاية الحرب الأهلية الأميركية في عهد أبراهام لنكولن وتوحيد الولايات.
في ساحة الكونغرس نهار السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، ارتفعت بالفعل أعلام الكونفيدرالية في أيدي المعترضين، فهل سيتكرر الأمر لاحقاً؟
في كل الأحوال تبدو أميركا مرشحة لقلق في النهار وأرق في الليل.